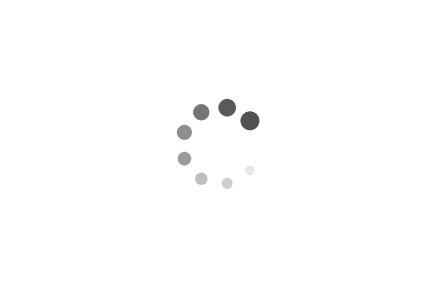لونا فرحات
لونا فرحات في خطاب السيد حسن نصر الله في 25/8/2024 وفي المحور الرابع منه، تحدث عن آلية وضوابط اختيار الهدف وطبيعة الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر من قبل العدو الإسرائيلي. إن المقاومة الإسلامية في لبنان قررت ألّا يكون الهدف مدنياً أو بنية تحتية، واختارت أن يكون هدفاً عسكرياً وله صلة بعملية اغتيال القائد شكر.
كان بإمكان المقاومة أن تستهدف أيّ موقع وأيّ رقعة جغرافية في الكيان الصهيوني، فصواريخها تصل إلى حيث تشاء ولكن قيادتها تضبطها ضوابط شرعية مصدرها الشريعة الإسلامية، وضوابط قانونية مصدرها القانون الدولي الإنساني في آن معاً. لقد أثبتت المقاومة الإسلامية في لبنان في كل ساحاتها وميادينها القتالية منذ تحرير الجنوب في عام 2000 وتحرير عرسال عام 2017 والآن في عمليات مساندة غزة، أنها مقاومة شريفة تعرف حقوقها وواجباتها الشرعية والدولية.
-66d206d5bc8c3.jpg)
يوضح هذا المقال المعايير القانونية الدولية التي يتعيّن على حركات التحرر الوطني والمقاومة المسلحة ضد الاحتلال مراعاتها واحترامها، وإلا فقدت مركزها القانوني والحماية التي يسبغها القانون الدولي الإنساني على مقاتليها. كما يستعرض أهم المعايير والضوابط الشرعية لاستخدام القوة المسلحة ضد العدوّ وفقاً للشريعة الإسلامية.
المقاومة "المشروعة" في القانون الدولي
تم تحديد مشروعية المقاومة في اتفاقية لاهاي لعام 1899 وانطباق قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها على المقاومة المسلحة بالنص على "أن قوانين الحرب وحقوقها لا تنطبق على الجيوش النظامية فحسب، بل أيضاً على رجال الميليشيات وفرق المتطوعين إذا ما توافرت فيهم الشروط الآتية: أن يكون على رأسهم شخص مسؤول. أن يحملوا السلاح علناً. أن يحملوا شارة مميّزة عن بعد. أن يقوموا بعملياتهم وفق قوانين الحرب. وأكدت اتفاقيات جنيف لعام 1949 على حق مقاومة الاحتلال الأجنبي، فالمادة 13 من اتفاقيّتَي جنيف الأولى والثانية تعترف صراحة بمشروعية المقاومة، إذ أكدت هذه المشروعية في المادة 4 والمادة 2 من الاتفاقية الثالثة لأسرى الحرب. وبناءً على ذلك، يحقّ لسكان الأراضي المحتلة مقاومة المحتل، سواء كانت المقاومة منظّمة أو غير منظّمة، والقانون الدولي يمنع سلطات الاحتلال من معاقبة المقاومين. وإذا تجاوزوا قوانين الحرب وأعرافها، فعلى سلطات الاحتلال توفير محاكمة عادلة لهم.
إضافة إلى ذلك، أقرّ القانون الدولي الإنساني منذ 1977 وضعاً خاصّاً لحركات التحرير الوطنية التي تقاتل الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية في ممارسة حقها في تقرير المصير. ويشبه البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 تلك الأوضاع بالنزاعات المسلحة الدولية، ويسمح بمنح أعضاء تلك الجماعات وضع المقاتل إذا حملوا السلاح علناً واحترموا قوانين الحرب.
إن استخدام العنف المسلح يقيّده القانون الدولي بقيود لكي يصبح مشروعاً، وعليه فإن أفراد القوات المسلحة الذين يحق لهم قانوناً أن يستخدموا العنف قد يتحوّلون إلى مجرمي حرب إذا انتهكوا قوانين الحرب. والقاعدة ذاتها تنطبق على أفراد المقاومة المسلحة وحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي. إن المقاومة ليست إرهاباً، والكفاح المسلح هو عمل عسكري ضد وجود أجنبي محتل يهدف إلى إنهاء الاحتلال والتحرر والاستقلال، في حين أن الأنشطة الإرهابية عادةً ما توجّه إلى أهداف داخل المجتمع وخارجه، هدفها المساس بالأمن القومي لدولة وأعمالها موجّهة ضد حكم أو أنظمة قائمة بحكم القانون.
كذلك يعدّ أسير المقاومة المسلحة محارباً قانونياً ويعامل معاملة أسرى الحرب وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1909 واتفاقية جنيف لسنة 1949، أما مرتكب العمل الإرهابي فيعامل معاملة المجرم العادي ولا يتمتع بأي خصوصية ويعاقب وفقاً للقوانين الجزائية الوطنية.
شرعية المقاومة أكدتها لاحقاً قرارات الأمم المتحدة؛ أوّلها القرار 1514 لعام 1960 المتعلق بمنح البلدان والشعوب المستعمَرة استقلالها، وكذلك القرار الرقم 3103 لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي لا بإضفاء الشرعية عليهم فحسب، وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة. والقرار الرقم 3246 الصادر في 14/12/1974 الذي أكد على شرعية المقاومة وذهب إلى أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والعنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي. أما المساعدة الدولية لحركات المقاومة فقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعية نضال الشعوب في سبيل التحرر بالوسائل كافةً، بما في ذلك القوة المسلحة، كما أقرّت تقديم دول العالم المساعدات للشعوب التي تناضل في سبيل تقرير المصير، وأن تدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المضمار، حيث يمكن لهذه الشعوب أن تتمتع بدعم خارجي في الكفاح المسلح التي تخوضه ضد دولة استعمارية أو عنصرية أو ضد الاحتلال الأجنبي.
الانتقام حقّ للمقاومة وفق القانون الدولي
وفي أوقات النزاع، تعدّ أعمال الانتقام قانونية بموجب شروط معينة وهي أنه: يجب أن تنفّذ ردّاً على هجوم سابق، وأن تكون متناسبة مع ذلك الهجوم، وأن تستهدف المقاتلين والأهداف العسكرية فقط.
وعليه، يحظر القانون الدولي كلّ أعمال الانتقام ضدّ المدنيين والأهداف الخاضعة لحماية اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها 1977، وتشمل الجرحى والمرضى أو الغرقى، والعاملين في المجال الطبي أو الديني، والوحدات، ووسائط النقل وأسرى الحرب، والأشخاص المدنيين والأهداف المدنية، والممتلكات الثقافية، أو أماكن العبادة، والأهداف الضرورية لحياة السكان المدنيين، البيئة الطبيعية، والمشاريع والمنشآت التي تحتوي على موادّ خطرة، والمباني والموادّ المستخدمة لحماية السكان المدنيين (اتفاقيّة جنيف المادة 46، اتفاقيّة جنيف 2 المادة 47، اتفاقيّة جنيف 3 المادة 13، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 33، بروتوكول 1 الموادّ 20 و51-56).
شروط الأعمال الانتقامية في إطار القانون الدولي الإنساني العرفي
بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي، يخضع استخدام الأعمال الانتقامية لشروط صارمة. وترد هذه الشروط في دراسة عن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005.
• القاعدة 145: تخضع أعمال الاقتصاص الحربي حيثما لا يحظر القانون الدولي لشروط صارمة.
• القاعدة 146: تحظر أعمال الاقتصاص الحربي من الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف.
• القاعدة 147: تحظر أعمال الاقتصاص الحربي ضد الأعيان التي تحميها اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
النزاع المسلح في إطار الشريعة الإسلامية
تضمن الشريعة الإسلامية لضحايا النزاع المسلح الحق في الحماية والاحترام والمعاملة الإنسانية. كما تدعو إلى حماية المرافق والممتلكات المدنية. وتقيّد الشريعة وسائل الحرب إلى حدود الضرورة العسكرية. كل هذا يتوافق بشكل كامل مع أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.
مبادئ القانون الدولي الإنساني الإسلامي
أولاً: وجوب حصر أعمال القتال كلها في ميدان المعركة ضد المقاتلين الأعداء وحدهم.
يحظر الفقه الإسلامي استهداف المدنيين وغير المقاتلين عمداً أثناء سير العمليات القتالية. وجاء في الأحاديث النبوية على ذكر خمس فئات من الناس يتمتعون بحصانة غير المقاتلين، وهم: النساء والأطفال والمسنّون والرهبان والعسفاء، أي الأجراء الذين يخدمون العدوّ ولا يشاركون في القتال معهم.
ثانياً: حظر استخدام الأسلحة العشوائية
حرص الفقهاء المسلمون على تأسيس أحكام بخصوص استخدام أسلحة عشوائية الطابع، استخدمت قديماً مثل المنجنيق والسهام المسمومة والسهام النارية وذلك لحماية الممتلكات العامة. (وتنطبق هذه القاعدة على الأسلحة الحديثة).
ثالثاً: حظر الهجمات العشوائية انطلاقاً من مبدأَيِ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ومبدأ الضرورة العسكرية. وفصّل الفقهاء أحكاماً تتعلق باستخدام أسلوبين من أساليب شن الحرب، هما: البيات أي الإغارة ليلاً، والتترس أي استخدام الدروع البشرية. وعلّة تحريم هذين الأسلوبين هي الحرص على عدم تعريض غير المقاتلين للخطر لتعذّر الرؤية. ووجد الفقهاء أن مهاجمة الدروع البشرية ربما تسفر عن أضرار جانبية. واتفق الفقهاء عموماً على ألّا يُستهدَف الأشخاص والأعيان المشمولون بالحماية عمداً.
رابعاً: حماية الأعيان بحسب الرؤية الإسلامية. فكل شيء في هذا العالم ملك لله، لذلك فإن التدمير الطائش أثناء سير العمليات العدائية لممتلكات العدوّ محظور حظراً صارماً. فالشعار الذي طبّقه المسلمون بتوصية من النبيّ الأكرم "لا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تهدموا بناءً، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تغرقوا نخلاً ولا تحرقونها". والإمام الأوزاعي يقول: لا يحلّ للمسلمين أن يفعلوا شيئاً ممّا يرجع إلى التخريب في دار الحرب لأن في ذلك فساداً، والله لا يحب الفساد". والإمام الشافعي يقول: "إن تعذيب ذوات الأرواح قادرة على الشعور بالألم، فأيّ أذى يلحق بها هو تعذيب لا مبرر له".
خامساً: حظر التمثيل بالجثث. تحرّم الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث تحريماً قاطعاً احتراماً للكرامة الإنسانية، وهو ما استوجب أيضاً دفن الموتى من الأعداء أو تسليمهم لبلدانهم عقب انتهاء القتال.
سادساً: معاملة أسرى الحرب. للفقهاء مواقف عدة، ولكنهم أجمعوا على ضرورة معاملة أسرى الحرب معاملة حسنة وإطلاق سراحهم من جانب واحد أو فداء بأسرى المقاتلين المسلمين.
سابعاً: الأمان، إذا طلب المقاتلون الأعداء الأمان في أرض المعركة يجب منحهم إياه وأن يعاملوا معاملة المدنيين المحميين.