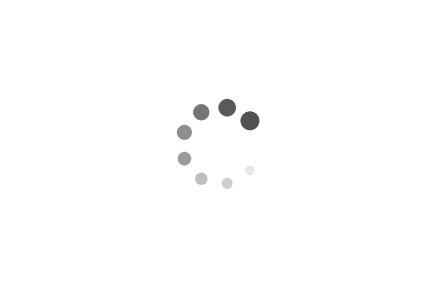ملاك سلّوم
ملاك سلّوم يعدّ اللاجئون الفلسطينيون من بين أكثر أفراد المجتمع ضعفاً، ويتعرّضون غالباً لتمييز يراوح بين العنف الجسدي أو المعنوي، والقيود المنهجية التي تحول دون الوصول إلى الخدمات مثل الإسكان والتوظيف والتعليم. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان وتدهور القطاع الصحي بسبب جائحة كورونا، ازدادت الأوضاع سوءاً داخل المخيّمات المكتظّة التي تفتقر إلى البنى التحتيّة الأساسية وأدنى مقوّمات العيش الكريم. فتنشط المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتؤدي دوراً أساسياً في تلبية الاحتياجات الأساسية لسد عجز الـ«أونروا» التي تتحمّل بشكل أساسي مسؤولية التخفيف من أزمات اللاجئين الفلسطينيين. إلا أنه مع ازدياد عدد الجمعيات وتوسّع أدوارها، عقب أزمة النزوح السوري، أصبح من الضروري تعزيز آليات التنسيق والتنظيم في تقديم المساعدات درءاً للفوضى والتزاماً بالشفافية، وبغية تحديد حاجات الأهالي والمخيّم ومعالجتها بمشاريع طويلة الأمد بدلاً من التوجه الدائم نحو تقديم المساعدات بطريقة عشوائية

«بحصة بتسند خابية»، هكذا يصف أهالي المخيم «كراتين الإعاشة» التي تُوزّعها المنظمات غير الحكومية التي توسّع دورها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. حتى عام 2012، بلغ عدد المنظمات والجمعيات العاملة في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 213 جمعية، بأحجام وقدرات مختلفة، وفق لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وشهدت هذه الأرقام ارتفاعاً إضافياً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتنقسم مجالات عمل تلك الجمعيات والمنظمات إلى نوعين: الخدماتية وتلك التي تعمل في الإطار الحقوقي والتوعوي. ومعظم هذه المنظمات فلسطينية، أما الدولية منها فلا تعمل بشكل مباشر، وإنما من خلال التنسيق أو التعاون مع الجمعيات الفلسطينية.
الإطار القانوني
تعمل المنظمات غير الحكومية في المخيمات الفلسطينية في إطار «الجمعيات اللبنانية»، وفق قانون الجمعيات العثماني الصادر عام 1909. إذ يلجأ الفلسطينيون إلى تأسيس جمعيات مع أفراد يحملون الجنسية اللبنانية، بحيث لا يحتاج إنشاء الجمعية إلى ترخيص، بل يقتصر على تقديم البيانات المناسبة مقابل منحها «علم وخبر». وتعمل الجمعية تحت إشراف وزارة الداخلية وفق القوانين المنصوص عليها. أما إذا كان أكثر من ربع المؤسسين من «الأجانب» أو كان أحد أعضاء مجلس الإدارة «أجنبياً» فيتم اعتبار الجمعية أجنبية، وبالتالي يتم تقديم طلب تأسيس «جمعية أجنبية» لدى وزارة الداخلية التي تحيله إلى مجلس الوزراء، على عكس المبدأ العام القاضي باكتفاء الجمعية بالتصريح.
تفاوت بالاستفادة بين اللاجئين
انعكست أزمة النزوح السوري على توجه الكثير من المنظمات العاملة في الوسط الفلسطيني. تشير فدوى، إحدى الناشطات الحقوقيات في إحدى الجمعيات إلى أنّ «المنظمات أصبحت تتوجه أكثر نحو تقديم الخدمات، كالألبسة والمؤن والمعونات، بعدما كانت تركّز سابقاً على التوعية الصحية والثقافية والحقوقية. ويعود هذا إلى التغيّر في التوجه العام للجهات المانحة، وخصوصاً الأجنبية منها التي تموّل هذه الجمعيات».
وفي هذا السياق، برزت أمام المنظمات غير الحكومية ثلاث مجموعات من اللاجئين: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والفلسطينيون النازحون من سوريا، والنازحون السوريون. وبحسب «نشرة الهجرة القسرية»، تتفاوت صعوبة الحصول على التمويل «الذي يسهّل إذا كان الهدف منه خدمة اللاجئين السوريين، لكنَّه يصعب إذا استهدف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ويصعب أكثر إذا استهدف اللاجئين الفلسطينيين من لبنان».
وتلفت فدوى إلى أنه يؤخذ على هذه الجمعيات عدم التنسيق في ما بينها في أغلب الأوقات، وعدم تغطية جماعات اللاجئين بالتساوي وبشكل عادل، إضافة إلى عشوائية عملية التوزيع. إذ «يمكن للاجئ الفلسطيني السوري أن يستفيد عشرات المرات من الخدمة المقدمة من مختلف الجمعيات، بدلاً من أن يحصل على خدمات مختلفة، ما ينعكس سلباً على الاستفادة الحقيقية منها، ويؤدي إلى بروز شكل من أشكال البيع والمتاجرة في هذه المساعدات أحياناً بين اللاجئين أنفسهم».
ويفسّر الباحث في الشؤون السياسية والإعلامية هادي قبيسي تفاوت الاستفادة بين مجموعات اللاجئين باشتراط الجهات المانحة والمنظمات الدولية بعقودها أحياناً على تخصيص نسبة مساعدات معيّنة لفئات دون أخرى، لأسباب سياسية، «لذلك توضع شروط في التمويل والعقود وفقاً لجنسية المستفيدين».
لا تدقيق
وحول الرقابة على أنشطتها، تؤكد جهات أمنية مختصة أن الجمعيات تحظى بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية والأمن العام قبل قيامها بأي نشاط، كما يشرف الأمن العام عليها، لكن من دون التدقيق كثيراً في الأرقام المصرّح عنها أو عن كمية المساعدات التي يتم إدخالها أو توزيعها، فيما تُرفع الحسابات والميزانية بشكل منتظم. وقبل أن تباشر هذه المنظمات العمل داخل المخيّمات، تبلّغ اللجان الشعبية المسؤولة في كل مخيّم حول طبيعة الأنشطة والمساعدات، وترسل أحياناً لوائح بأسماء موظفيها والعاملين فيها.
ضعف في تشخيص الحاجات
بالتوازي مع تعَزّز الجانب الخدماتي في عمل هذه الجمعيات، شهدت المخيمات الفلسطينية في السنوات الأخيرة ازدياداً في الأنشطة واللجان التي تُعنى بتمكين المرأة وتطوير وتحسين كفاءتها، والصحة النفسية، إضافة إلى شبكات حماية الطفل. لكن، في مرات عديدة، لاقت تلك الأنشطة معارضة دينية وقيمية وثقافية من أهالي المخيّمات. لذلك تضطر الجمعيات غير الحكومية إلى مراعاة الجانب الاجتماعي في أشكال الأنشطة أو حتى الشخصيات غير الفلسطينية التي كانت تقدمها أحياناً.
يرى مجد، أحد الذين عملوا لسنوات طويلة مع هذه الجمعيات، أن الكثير منها «أصبحت تعمل وفق ما يجذب التمويل، وبالتالي تقدّم مقترحاتها للجهات المانحة بناءً على هذا المعيار، لا وفق حاجات الناس الفعلية داخل المخيّم». ويضيف: «في رأيي، أسوأ ما ساهمت به هذه الجمعيات هو تكريس مفهوم الحصول على مورد مالي مقابل الحافز الذاتي أو التطوّع والتضامن المجتمعي، وهذا يتناقض أصلاً مع مفهوم التمكين الذي تنادي به الجهات المانحة. فالهدف هو بناء القدرات لا المال».

«ازدهار» في ظل ضعف الأونروا واستمرار الحرمان
تتعدّى، أحياناً، الجمعيات غير الحكومية العاملة في المخيمات الفلسطينية الأدوار المنوطة بها لتحلّ مكان الـ«أونروا» في كثير من الأوقات، كالقيام بحملات تنظيف، واستئجار مبانٍ للتعليم، وصولاً إلى توفير الأدوية. رغم ذلك، بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين، تُصبح هذه المنظمات ضرورة -في ظل مستويات فقر قياسية- لسد الحاجات الأساسية بشكل مؤقت، حتى لو كانت كمية المساعدات قليلة وجودتها متدنّية، ولخلق مورد مالي، في وقت يستمر فيه حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الاقتصادية والمدنية، ما يخلق حاجة إلى تنظيم وتنسيق برامج عمل الجمعيات من جهة، وتحديد أطر تدخّل الجهات المانحة في تشكيل نوع واتجاه المشاريع التي تقوم بها داخل المخيّمات من جهة أخرى. أضف إلى ذلك الحاجة الملحّة للرقابة على عملها.